هَمَسَاتُ فِكر(78)/عزيز الخزرجي
Wed, 15 Jun 2016 الساعة : 10:06
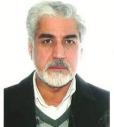
ألحقيقيّ و آلمَجازيّ:
من أهمّ خصوصيات اللغات ألخمسة ألحيّة (1)؛ هي خصوصية (المجاز) التي تفوق خصوصية (الحقيقة) التي تُميّزها عن غيرها من اللغات الكثيرة في العالم و التي تتعدى آلخمسة آلاف لغة, بجانب آلأدوات اللغويّة و الأعرابيّة و آلبلاغيّة و علم العروض و آلبيان و البديع ألتي أضْفَتْ مجتمعةً المزيد من آلجّمال و القوّة و المتانة و الأبداع و البلاغة على تلك اللغات, و لعلّ آللغة العربيّة التي أختارها الله تعالى لتكون لغة القرآن آلمعجزة الخاتمة تتقدّم على جميع تلك اللغات لسعة معانيها و قدرتها على التّعبير و آلبيان ألواضح الرّصين المحكم و بإسلوب مجازيّ تشبيهي لمعرفة ال
قضايا و الوقائع و الظواهر و العلوم و العوالم التي يصعب على العقل الأنساني الوصول إليها و دركها على حقيقتها!
و لذلك فأنّ معجزة القرآن تتجسد بآلأضافة لذلك في محاور أخرى عبر بيان النّظريات العلميّة و الأسرار الكونية و آلأفاقية و آلنفسية التي إحتوتها بإسلوب جميل بجانب إستباق الزمن في كشف الظواهر العلميّة و الحقائق التأريخيّة لتشكّل بحقّ معجزة القرآن الخالدة كخاتم لجميع الكتب و الرّسالات السّماوية.
لذلك كان من الضّروري معرفة ماهية التعبير (الحقيقيّ) و (آلمجازيّ) بشكلٍ خاصّ, بإعتبارها الأساس الذي ترتكز عليه معجزة القرآن لفهم حقيقة الوجود و ما فيه من آلألغاز و الأسرار و آلغايات بشكل أدقّ و أوسع و أعمق.
التعبير (الحقيقيّ) ثمّ (المجازيّ) ألفاظ تُعبّر عن آلفكر الذي يُمثّل حقيقة و جوهر الأنسان لأنه يُحدّد مكانتهُ في الوجود لدرجة إكرامه و تفضيله من قبل الخالق على كثير من آلخلق، و يخضع للتّبدل و آلتّغير مع تطوّر العلوم و تقدم الزّمن و مدى سعي الأنسان في التعمق بتلك آلمعرفة التي تُحقّق اليقين في وجود الأنسان.
و تمتاز اللغة العربيّة عن لغات العالم بخصوصيات فريدة, تعطي للمتكلمين قدرات بلاغية يمكنهم معها الوصول إلى كامل و غاية المعنى المراد معرفته من خلال عبور آلألفاظ الحقيقيّة إلى إستعمالات اللغة المجازية .. التي بدونها يستحيل الوصول إلى معرفة آلحقيقة المطلقة و هي الله من خلال فلسفة الوجود, حتى و إن كانتْ الأثباتات العلميّة تؤكد تلك الحقيقة.
لأنّ طبيعة الرّوح الأنسانيّة و قلبه لا يطمئن و لا يرتاح كثيرأً للحقائق العلميّة المجرّدة بقدر إستئناسها و دركها للحقائق المجازيّة التي تتناغم أكثر مع الحواس الخمسة و مع عالم الرّوح الحساسة جدّاً .. بآلضبط كمآ هو الحال مع آلألوان المستخدمة في الرسم, حيث لا ترتاح الرّوح للألوان الصّريحة بينما تنجذب للألوان الغير الصّريحة لسحرها و لقوّة جاذبيتها و غرابتها, حيث يستأنس و يلتذ بها الناظر أكثر, لأنّ من طبيعة النفس الأنسانية سرعة اصابتها بالملل في حال تكرار المكرّرات التي يراها دائمأً في الموجودات المألوفة!
و كذلك لعدم وجود وسيلة أخرى - للبشر الذين يبلغون درجة الآدميّة - للتعبير عن آدميّتهم و كشف آلأسرار الغامضة و ماهيّة وجودهم الحقيقيّ و معرفة الخالق .. سوى آللغة لدرك و وعي و كشف تلك الحقائق التي أشارت لها الكتب السّماوية و على رأسها القرآن الكريم؛ لذلك حلّ (المجاز) بَدَلَ (التَّصريح) المُمّل كأمْثَل بديلٍ لتوضيح آلكثير من القضايا الأساسيّة التي طرحها القرآن الكريم بدءاً بصفات و عظمة الله تعالى و أبعاد و حقيقة الوجود و أسرار الكون و إنتهاءاً بمكانة و آفاق الأنسان و سبب وجوده, إلى غيرها من الموضوعات الكونيّة ألأساسيّة(2) التي لا تستيطع كلّ العلوم
الطبيعيّة من بيانها!
لذلك حلّ المجاز لبيان تلك الموضوعات الأساسيّة التي تعطي للفكر الأنساني مساحات كبيرة و آفاقاً واسعة للتدبّر و التّأمل و التّفكر و التّعقل الذي يستطيع إختصار المسافات و الأزمان لسبر أغوار هذا الوجود آلغامض .. اللامتناهي على ما يبدو!
إنّ الهدف الأساسيّ من وراء إستخدام اللفظ المجازي:
هو آلحصول على أوسع آلأبعاد و أقصى المديات ألمُمكنة لمعرفة ألحقيقة آلكامنة وراء الحقائق الكونيّة – الوجوديّة و أبعاد العلاقات الشخصيّة – آلأجتماعيّة و تأثير النُّظم عليها .. لرسم حياة أفضل لها معنى يتحقق بضلالهِ فلسفة الوجود و في مقدمتها سعادة آلأنسان.
فالحقيقة اللّغوية: هي ما أقرّ في الأستعمال على أصل وضعه في اللغة و فَصَّلَ معناهُ آلمعاجم و آلقواميس اللغوية.
و المجاز اللغويّ: يتعدّى بيان آلأصل آلموضوعٍ في آللغة لمعرفة المخلوقات أو الخالق .. إلى آلتعابير المجازيّة, حيث يعدل إليه نيابة عن آلتعابير الحقيقية لتحقيق أهدافٍ ثلاثة هي:
-- ألاتساع في الفهم,
-- آلتأكيد على مكانته و اهميته,
-- ألتّشبيه ألذي يسعى لتقريب ألصّور التي تختلف سنخيتها عن سنخية الظواهر و الوقائع و آلأجسام كظاهر الأنسان(الجسد) ليدركها الذهن و آلقلب بشكلٍ أكمل.
فإنْ عَدَمَ هذه آلأوصاف من اللفظ الذي هو (المجاز)؛ كانت (الحقيقة) البتة.
بإختصار أبلغ؛ (المجاز) تعبير عن (الجّوهر), بينما (الحقيقة) تعبير عن (العَرض).
فآلّذي يبني لَكَ بيتاً في قلبهِ, هو تعبيرٌ مجازيّ عن شدّة و مدى و سعة عشق آلمفتون بكَ, بينما لا وجودَ لهذا آلبيت(الحقيقيّ) في آلواقع المرئي(المنظور) لتجرّده من الأسباب المنظورة و الملموسة(3).
و عموماً فإنّ اللغة و ما تتميّز بها من جماليات و قدرات إعجازيّة يُمكن توضيفها من خلال ألمجاز لتُعبِّر عن إمكانيّة التواصل بين البشر بكلّ ما يحملون من أعباء و أفراح و أحزان من جهة؛ و بين البشر و الطبيعة من جهة أخرى؛ بآلأضافة إلى كشف العلاقة التي تربط تلك المخلوقات(البشر و الطبيعة) بآلله تعالى.
فدور المجاز في تلك العلاقات, هو تسهيل الفهم لتضيّق المسافة الإدراكية ثمّ العمليّة - كإنعكاس لذلك الأدراك والوعي القلبي - التي تفصل بين الخالق و المخلوق؛ بين الإنسان و أخيه الإنسان؛ بين الأنسان و الطبيعة؛ بين الواقع و الخيال.
كما إنّ آللغة المجازية بوسعها آلأشارة إلى الوجود الإلهي المتجاوز, و كذلك إلى الوجود الإنساني المركب الذي يُردْ إلى عالم المادة.
و أنّ عَدَمَ أو ضَعَفَ فكرة المجاز في اللغة؛ فأنه يسبب إنعدام وجود .. أو ضعف في تلك (العلاقة) أو ربما تسبب إلتحام كامل كـ (وحدة الوجود) و (الحلولية), وتلك قضية معقدة تدخلنا في عالم العرفان الذي بيّنا سابقاً مساراته و محطاته السبعة المعروفة.
و لكنّ اللغة المجازيّة حين تجسّدَتْ خلال الأفكار الفلسفية بشيئ من التطرف آلسّلبي لأهداف عنصرية, كانت مفتاحاً لتفسير و تحليل بعض آلأحداث و السّياسات لبعض الحقب التاريخية و الأنظمة الدّولية كما في آلحركة الصّهيونية و النازيّة و الوهابيّة و البهائيّة.
و عن الصّورة المجازيّة الإدراكيّة يعتقد اللغوييون، بكون لجوء الإنسان إلى إستخدام (المجاز) هو لزيادة التعبير قوّةً و تأثيراً و مساحةً كما أشرنا، فقد يكون مجرّد زخارف في بعض الأحيان و لكنه في أكثر الأحيان يكون جُزءاً أساسياٌ من التفكير الإنسانيّ الهادف.
فالمجاز يقوم بعمليّة زيادة في نطاق اللغة الإنسانيّة و يجعلها أكثر مقدرة على آلتّعبير عن آلإنسانيّ المركب و اللامحدود عن طريق ربط المجهول بالمعلوم و الإنساني بالطبيعي و المعنوي بالمادي و اللامحدود بالمحدود!
أيّ أنّ الحركة العامّة للمجاز هي ربط عالم الشّهادة المحسوس بعالم الغيب الغير محسوس ليصبح غير المعروف وغير المحسوس أكثر دركاً و قُربا منّا نحن البشر الذي نعيش في عالم المادة و داخل حدوده، و إنْ كنّا دون الطموح للوصول إلى الحقيقة النهائيّة .. و دون السقوط في العدميّة المطلقة، فيصبح المجاز اللغويّ أداة الإنسان السّوي الهادف للتعبير عن أفكار و رؤى يُمكِن التعبير عنها لغوياً بتلك الطريقة.
تُشكّل آلصّورة المجازيّة كلّ أشكال و أبعاد المجاز، لتكون وسيلة إدراكيّة لا يمكن للمرء أن يدرك واقعه دونها، و يُمكن أيضاً إستخدامها كوسيلة لتمرير التحيزات و فرضِها بدقة بشكل خفيّ، فالمجاز يقوم بترتيب تفاصيل الواقع بنقل رؤية معيّنة.
إنّ كلّ حضارة .. بل حتّى مشروع صغير؛ له صورتان مجازيّتان, هما:
الصّورة الأليّة؛ و هي التي تُصوّر العالم في حركة مرئية دائمة كالألة،
الصّورة العضويّة: التي تُصوّرالعالم كائن حيّ و في حالة حركة دائمة،
يعوِّل النموذج ألآليّ في آلأساس على آلفكر اليونانيّ القديم ألذي إكتسبَ مركزيّة خاصّة للثورة الصّناعية – التجاريّة - حتى عصر النّهضة الغربيّة الحديثة.
أمّا آلصّورة المجازيّة العضويّة، فيشغل مكان أكثر مركزيّةً و مصداقاً في عصر أفلاطون و أرسطو و لونجينوس، و لكنه إكتسب مركزيته في القرن التاسع عشر بعد آلنّهضة ألحديثة، و قد تُعبِّر أيضا تلك المجازية العضوية عن إزدياد الحلوليّة (الكمونيّة) و (العلمنة) معاً عبر تآلف غير منطقي أذلت الأنسانية بأبشع صورة بدت ظاهرها حضارية لكنها كانت تمثل جهنم الدنيا داخلياً.
و الحضارة الحديثة كما يعتقد المؤرخين بناء على (آلرّؤية المجازيّة) هي خليط من (العضويّة) و (آلألية) أو (تاريخ بينهما) بعيدأً عن الغيب، و يتمثل التشبيه في ذلك المعنى بأسطورة (بروميثيوس) التي يراها الكثيرين الصّورة المجازيّة العلمانيّة الأساسيّة، فهو يُعبّر عن رمز ألإنسان ألذي يتمرّد على القوى الغيبيّة التي تريد فرض هيمنتها عليها عن طريق تطوير ألعلم ليهزم الطبيعة، و يصبح بذلك هو ذاته إلهاً مكتفياً بذاته.
عزيز الخزرجي
للتّواصل؛ عبر(آلمنتدى آلفكْريّ)؛
https://www.facebook.com/AlmontadaAlfikry
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هي على التوالي: العربية – الأنكليزية – ألفرنسية – الصّينية - الفارسية
(2) هي: من أين أتيت؟ و لماذا أتيت؟ و كيف أتيت؟ و مع من أتيت؟ و كيف سترجع؟ و إلى أين ترجع؟
(3) آللفظ (الحقيقيّ) ينقسم لثلاثة أقسام هي:
ألأوّل: الحقيقة اللغوية (الوضعية).
ألثاني: الحقيقة العرفية (التقليدية).
ألثّالث: ألحقيقةُ آلشّرعيّة (ألعلميّة).
-- فاللغوية (ألوضعيّة): هي آللفظ ألمستعمل فيما وضع له أولاً في اللغة، كالأسد المستعمل في الحيوان الشّجاع المعروف.
-- و العرفية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بعرف الاستعمال اللغوي وهي ضربان:
عرفية عامة, وعرفية خاصة.
-- و الشرعية, هي اللفظ المستعمل للتعبير عن طقوس و أحكام و مبادئ, كآلصّلاة و الصّوم و الحَجّ.
-- فمن الأول(الوضعيّة): أن يكون الأسم قد وضع لمعنى عام، ثمّ يُخصّص بعرف استعمال أهل اللغة ببعض مسمياتة، كإختصاص لفظ (الدابة) بذوات الأربع عرفا، وإن كان في أصل اللغة لكل مآدب.
و منه: أن يكون الاسم في أصل اللغة بمعنى، ثم يشتهر في عرف استعمالهم بالمجاز الخارج عن الموضوع اللغوي بحيث إنه لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه غيره، كاسم الغائط فإنه وإن كان في أصل اللغة للموضع المطمئن من الأرض، غير أنه اشتهر في عرفهم بالخارج المستقذر من الإنسان. حتى إنه لا يفهم من ذلك اللفظ عن إطلاقه غيره.
-- و من العرفية الخاصة ما تعارف عليه أهل كل فن كالحد والرسم عند المناطقة، والرفع والنصب عند النحاة، والكسر والقلب عند الأصوليين ونحو ذلك.
-- و أما الحقيقة الشرعية: فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل الشرع، كاسم الصّلاة، و الزكاة، و الحج و نحوها.
أما آللفظ(المجازيّ) فينقسم لعدّة أقسام، أهمّها أربعة و هي:
مجاز الإفراد.
مجاز التركيب.
المجاز العقلي.
مجاز النقص و الزيادة.
فمجاز الإفراد: هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي كإطلاق لفظ (الأسد) على الرّجل الشجاع.
والتركيب: أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام آخر، لعلاقة بينهما دون نظر إلى المفردات، ومن ذلك جميع الأمثال السائرة، المعروفة عند العرب.
و المجاز العقلي: هو ما كان التجوز فيه في الإسناد خاصة، لا في لفظ المسند إليه ولا المسند، كقولك "أنبت الربيع البقل"، فالربيع وإنبات البقل كلاهما مستعمل في حقيقته، والتجوز: إنما هو في إسناد الإنبات إلى الربيع، وهو لله جل وعلا.
و أما مجاز النقص و الزيادة: فمداره على وجود زيادة، أو نقص يغيران الإعراب، ويمثلون للنقص بقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}، و المراد أهل القرية.
و يمثلون للزيادة بقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}, و يقولون إنّ الكاف زائدة و المراد ليس مثله شئ.
و هناك أقسام أخرى كمجاز التقديم و التأخير، و غيره.


